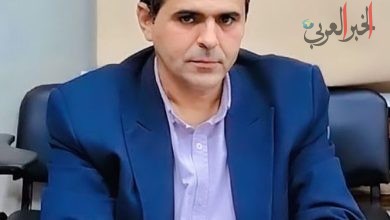الإسلام في القرن العشرين

بقلم / محمـــد الدكـــروري
الحمد لله العلي العظيم القاهر، الملك السلطان القادر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أحمده سبحانه على ما أولانا من بره وإحسانه المتظاهر، وأشكره وقد وعد بالمزيد للشاكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المؤيد بالآيات والمعجزات والبصائر، اللهم صلي على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد إن هناك وسائل تبعث علي اليقظة وتوقي شر كل معتد ومعرفة أسلوبه الملتوي منها هو عدم حسن الظن به أي بالعدو الكافر دائما وأبدا، وإعداد العدة الحربية بحسب القدرة على ذلك لقوله تعالى ” وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ” وأيضا إسناد أمر القيادات الحربية إلى ذوى الكفاءات من القدرة البدنية والعلمية الحربية والإيمانية الروحية.
ووجود خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة عليمة، ووجوب أخذ الأهبة، والاستعداد التام في أيام السلم، وأيام الحرب على حد سواء، وأيضا وحدة الكلمة ووحدة الصف إذ الفرقة محرمة، وأيضا طاعة الله تعالي وطاعة رسوله بصورة عامة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب المناهى في الحرب والسلم معا، حيث إن الذنوب موجبة للعقوبة من الله تعالى، وقد تكون هزيمة بالعدو، والعياذ بالله، ولابد من الحذر، لأن من الناس من يعيشون على هفوات الآخرين وأخطائهم، بل قل يعيشون على كلمة الحق إذا قيلت، فيكتبون ويتجسسون والتجسس لا يكون في محيط المسلمين، ولا يكون إلا على أعداء الله عز وجل، وان أعظم الغلط هو الثقة بالناس، والاسترسال إلى الأصدقاء، فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا.
لأنه قد اطلع على خفي السر، فقال منصور الفقيه احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مره، فلربما انقلب الصديق عدوا فكان أعلم بالمضره، واعلموا يرحمكم الله إن الإسلام في القرن العشرين، أخذ يظهر كقوة عالمية يستمد قوته، ليس من القدرة العسكرية الاقتصادية، التي تحمل مخاطر إشعال الحرائق والحروب تنافسا على الثروة، وفرضا لمبدأ الهيمنة، بل كمقدم لمشروع حضاري إنساني متكامل، حاملا الخلاص للعالم، والنجاة للإنسانية المهددة بالانهيار الروحي والتشويه الإنساني، وانحطاط القيم الثقافية والحضارية، حيث تسمح ديمومة القناعة الدينية، بالتشديد على صلاح الإسلام للزمن الراهن عن طريق أمثلة مستقاة من الحقبة المعاصرة ومن الماضي، وقد احتفظنا من القانون الإسلامي بما اعتبرناه ثابتا لا يتحول.
لا بوصفه قواعد ابتدعها أو استنتجها الفقهاء، إنما بوصفه تعبيرا عن إجراء روحي مرتبط بحضارة خاصة، وجوهر لقانون وهبه الخلاق العليم جل جلاله، فهو من هذه الناحية، وبصورة عامة جدا، مثالي وثابت، وهكذا اهتم التفكير القانوني بالمحافظة على النظام المجتمعي، أكثر من اهتمامه ببناء مجتمع، وراح يتطور مع نمو المجتمع، وأكسبه مظهره الذممي مرانا كبيرا، ولم يعمل المظهر القانوني على عكس صورة عن الواقع بالتطابق مع الأحداث، بل كان مفروضا فيه على العكس أن يوجهها بوصفه علما نظريا مرتبطا مع الأحداث، بل كان مفروضا فيه على العكس أن يوجهها بوصفه علما نظريا مرتبطا بجوهر القانون وهو الوحي وخاضعا له.